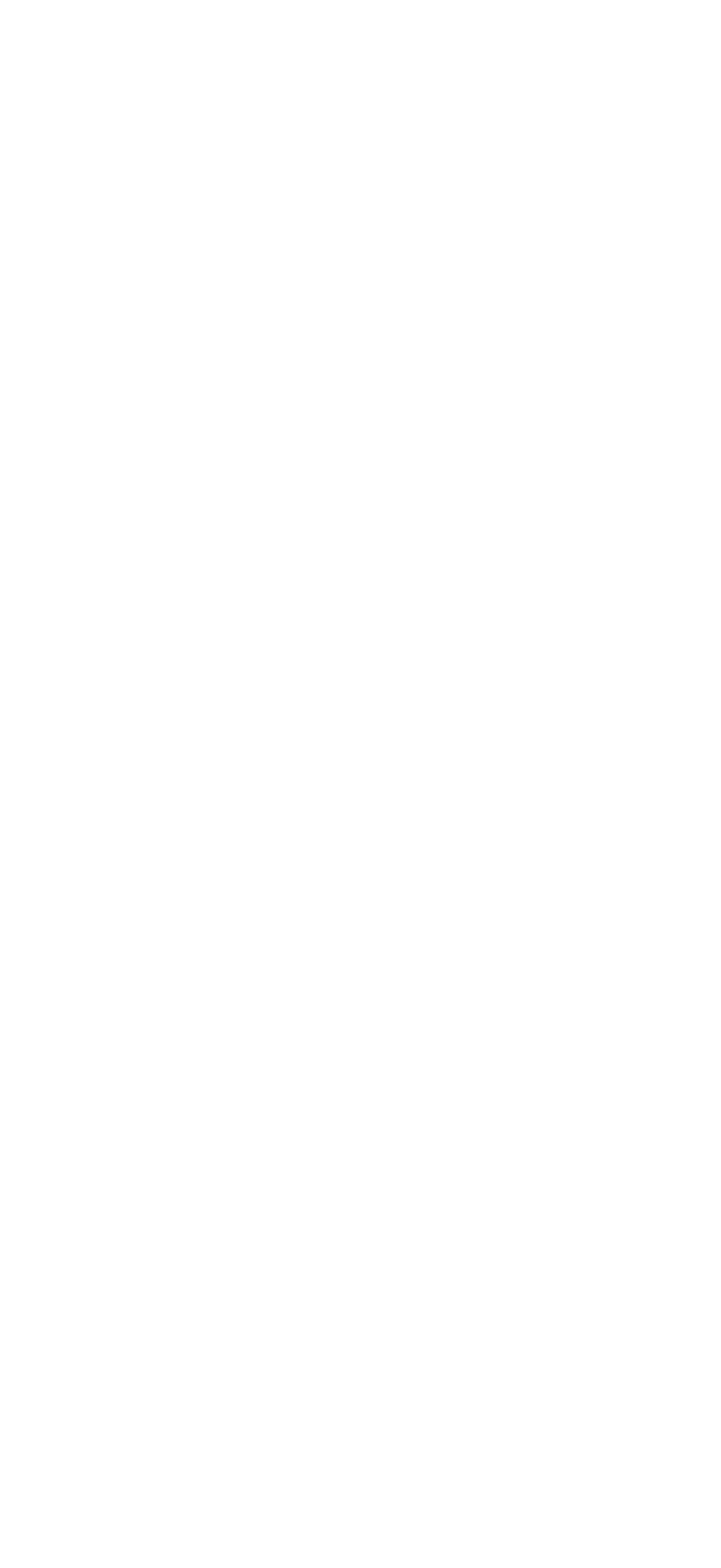التفاصيل

"التشريع أم التنظيم؟ تأثير النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على اختصاصاتها"
"التشريع أم التنظيم؟ تأثير النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على اختصاصاتها" د. ماجد الربيعي يُعد مبدأ المشروعية أحد الأسس الجوهرية في النظام القانوني، والذي يقتضي أن تكون جميع تصرفات السلطات العامة مستندة إلى نص قانوني صريح، وألا تتجاوز حدود الاختصاصات الممنوحة لها بموجب التشريعات النافذة. وفي هذا السياق، يثور التساؤل حول مدى مشروعية منح المحكمة الاتحادية العليا لنفسها اختصاصاً بالنظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض، وفقاً لما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022، رغم أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 لم يتضمن نصاً صريحاً يخولها هذا الاختصاص. إن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 هو التشريع الأساسي الذي يُحدد صلاحيات واختصاصات المحكمة، وهو المصدر القانوني الأعلى الذي يجب أن تستند إليه جميع الأنظمة الداخلية والإجراءات التي تصدرها المحكمة. وقد نصت المادة (9) من هذا القانون على ما يلي: “تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.” يُفهم من هذا النص أن الغاية من النظام الداخلي هي تنظيم الإجراءات الداخلية للمحكمة، وليس منح المحكمة اختصاصات جديدة لم يقررها القانون. وبالنظر إلى طبيعة الاختصاصات التي منحها قانون المحكمة الاتحادية العليا، نجد أن المحكمة تختص بموجب المادة (4) من القانون بالفصل في القضايا الدستورية، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وغيرها من الاختصاصات ذات الطابع الدستوري والقانوني. ولم يتضمن القانون أي نص يخول المحكمة اختصاص القضاء المستعجل أو إصدار الأوامر على العرائض. نصت المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 على ما يلي: “للمحكمة النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على عرائض وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 المعدل أو قانون يحل محله.” وهنا يبرز إشكال قانوني جوهري: هل يحق للمحكمة الاتحادية منح نفسها هذا الاختصاص من خلال نظامها الداخلي؟ من الناحية القانونية، فإن النظام الداخلي هو أداة تنظيمية تُستخدم لضبط سير العمل داخل المؤسسة القضائية، لكنه لا يمكن أن يُنشئ اختصاصات جديدة لم ينص عليها القانون. ذلك أن الاختصاص القضائي هو مسألة تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز تقريره أو تعديله إلا بموجب نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية. وبالرجوع إلى المبادئ القانونية المستقرة، فإن هناك قواعد أساسية تحكم تفسير النصوص المتعلقة بالاختصاص، ومن أهمها: 1. مبدأ تدرج القواعد القانونية: لا يجوز للنظام الداخلي، وهو نص تنظيمي أدنى مرتبة من القانون، أن يخالف أو يضيف إلى نص تشريعي صادر عن البرلمان. 2. مبدأ حصر الاختصاص القضائي: لا يجوز لمحكمة أو هيئة قضائية أن تمنح نفسها اختصاصاً غير منصوص عليه في القانون التأسيسي الذي أنشأها، لأن ذلك يُعد تعدياً على السلطة التشريعية. 3. مبدأ عدم التوسع في الاختصاصات القضائية: الأصل في الاختصاص القضائي أنه مقيد بالنصوص القانونية، وأي توسع فيه يجب أن يكون بموجب تعديل قانوني صريح صادر من السلطة المختصة، وليس بقرار تنظيمي داخلي. بناءً على ذلك، فإن المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تعدّ مخالفة لمبدأ المشروعية، كونها أضافت اختصاصاً جديداً للمحكمة لم يرد في قانونها التأسيسي، الأمر الذي يُثير شبهة عدم الدستورية لمثل هذا النص التنظيمي. إن المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا منحت المحكمة سلطة إصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل والإجراءات أمامها، لكنها لم تمنحها الحق في تعديل أو توسيع اختصاصاتها. وهذا يتماشى مع القاعدة العامة التي تقضي بأن الأنظمة الداخلية لا يجوز أن تتجاوز حدود التفويض التشريعي الممنوح لها. تُعد المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية المنصوص عليه في الدستور العراقي، وخاصةً مخالفة نص المادة (47) الذي يُكرّس مبدأ فصل السلطات، والذي ينص على أن “تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.” وبناءً عليه، فإن تحديد الاختصاصات القضائية هو من اختصاص السلطة التشريعية فقط، ولا يجوز لأي جهة قضائية أن تُضفي على نفسها اختصاصات جديدة غير منصوص عليها في النصوص التشريعية. ومن هنا، فإن إضافة المادة (39) في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، التي تمنح المحكمة اختصاصاً في النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض دون وجود نص قانوني يسمح بذلك، تُعد تعدياً صارخاً على صلاحيات البرلمان وتجاوزاً للحدود الدستورية، مما يجعلها قابلة للطعن بعدم مشروعيتها استنادًا إلى نص المادة (47) من الدستور. تستند إمكانية الطعن في هذا النص التنظيمي إلى المبادئ التالية: 1. مخالفة مبدأ المشروعية: حيث استُحدث اختصاص قضائي دون سند نصي قانوني. 2. انتهاك نص المادة (47) من الدستور: الذي يقيد السلطات بحدود اختصاصاتها الممنوحة من قِبل السلطة التشريعية. 3. مخالفة قاعدة تدرج القواعد القانونية: إذ لا يجوز للنظام الداخلي – الذي يعد نصاً تنظيمياً أقل مرتبة – أن يُضيف اختصاصات تتعارض مع القانون الأساسي. 4. تجاوز القواعد العامة في الاختصاص القضائي: إذ لا يجوز لأي جهة قضائية أن تُمنح لنفسها اختصاصات لم ينص عليها المشرّع. استناداً إلى ما تقدم، فإن نطاق اختصاص المحكمة الاتحادية العليا يُحدد بموجب قانونها الأساسي رقم (30) لسنة 2005، الذي يشكل الإطار القانوني الحاكم لعملها، ويُرسّخ مبدأ المشروعية الذي يُلزم جميع السلطات، ولا سيما السلطة القضائية، بالالتزام بالصلاحيات المقررة لها دون تجاوزها أو التوسع فيها بوسائل غير تشريعية. وبما أن النظام الداخلي هو أداة لتنظيم العمل الداخلي للمحكمة وليس وسيلة لمنحها سلطات جديدة، فإن أي نص يَرِد فيه ليضيف اختصاصات لم يرد ذكرها في القانون التأسيسي للمحكمة يُعد مخالفةً قانونية وانتهاكاً لمبدأ تدرّج القواعد القانونية. كما أن ذلك يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور العراقي، التي تؤكد على الفصل الواضح بين السلطات وعدم جواز تعدي إحداها على اختصاص الأخرى. ولأن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والفصل في النزاعات الدستورية، فإن أي توسيع لاختصاصاتها ينبغي أن يتم من خلال تشريع يصدر عن مجلس النواب، باعتباره الجهة المخولة قانونًا بتعديل صلاحيات السلطات العامة. أما محاولة المحكمة إضافة اختصاصات جديدة لنفسها من خلال أوامر ولائية أو تنظيمات داخلية، فإنها تُعد تجاوزاً لصلاحياتها وخروجاً عن الإطار الدستوري والقانوني. وهنا يُثار التساؤل حول طبيعة القرارات الصادرة بناءً على هذا التوسع غير المشروع، وما إذا كانت تُعد معدومة أم مجرد قرارات باطلة قابلة للإلغاء. إن القرار يُعد معدوماً قانوناً إذا صدر عن جهة لا تملك الاختصاص مطلقاً، بحيث يكون غير منتج لأي أثر قانوني منذ لحظة صدوره، ويجوز الدفع بانعدامه في أي وقت دون التقيد بالمدد القانونية للطعن. أما القرار الباطل، فيظل نافذاً حتى يُلغى بقرار من جهة قضائية مختصة. وبما أن إصدار المحكمة لأوامر ولائية دون نص قانوني يُخوّلها ذلك يمثل افتقاراً لاختصاص جوهري، فإن هذه الأوامر تُعتبر معدومة الأثر قانوناً، مما يمنح أي متضرر الحق في الدفع بانعدامها أمام أي جهة قضائية دون قيود زمنية. وبناءً على ذلك، فإن أي توسيع لاختصاص المحكمة خارج الإطار الذي رسمه القانون، سواء من خلال نظامها الداخلي أو عبر إصدار أوامر ولائية لا تستند إلى سند تشريعي، يُشكل انتهاكاً صريحاً لمبدأ المشروعية، ويُهدد مبدأ الفصل بين السلطات. ولتفادي أي إخلال بالتوازن الدستوري، فإن أي تعديل في صلاحيات المحكمة يجب أن يتم عبر تشريع برلماني، لا من خلال قرارات تصدرها المحكمة نفسها، لضمان احترام سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشرعية الدستورية.