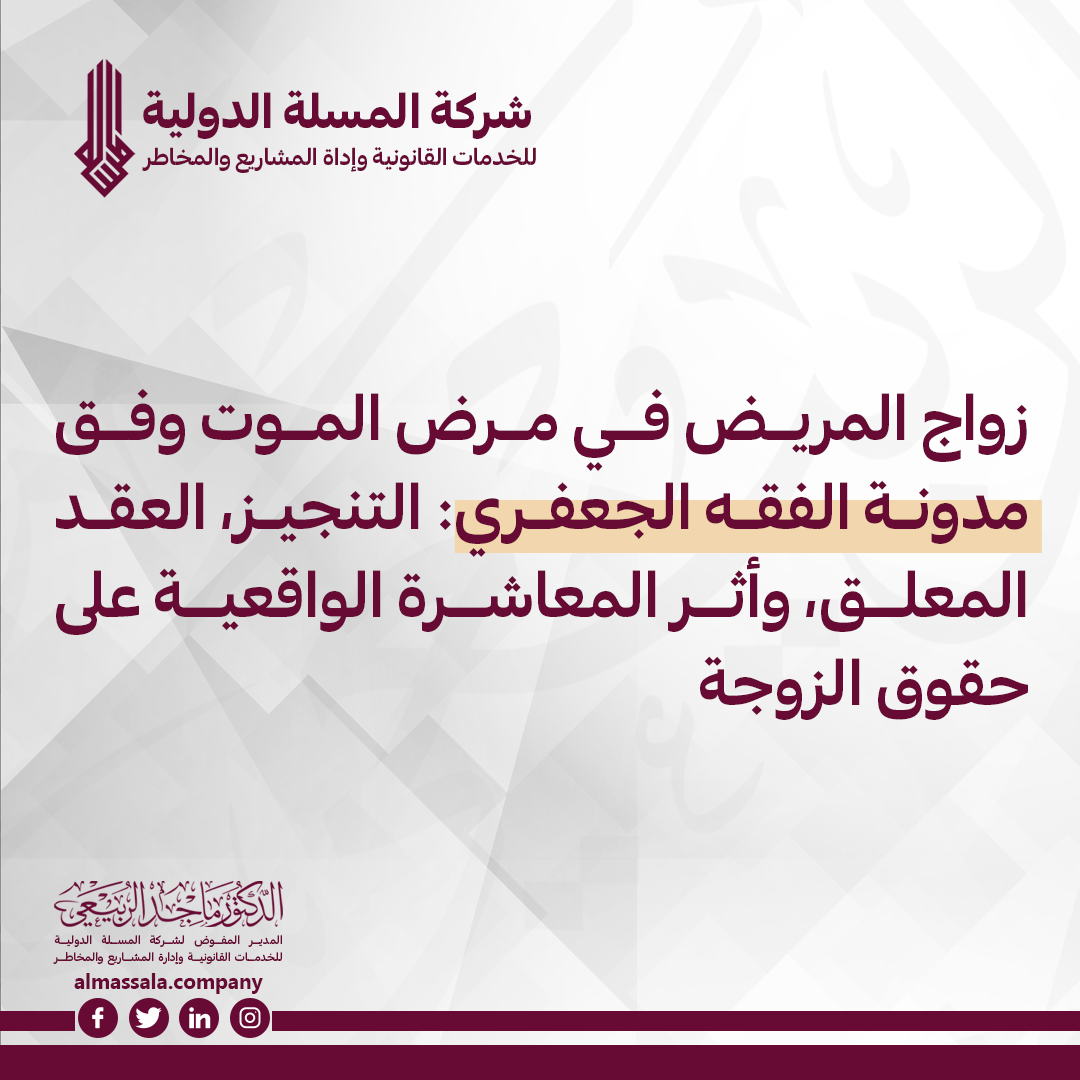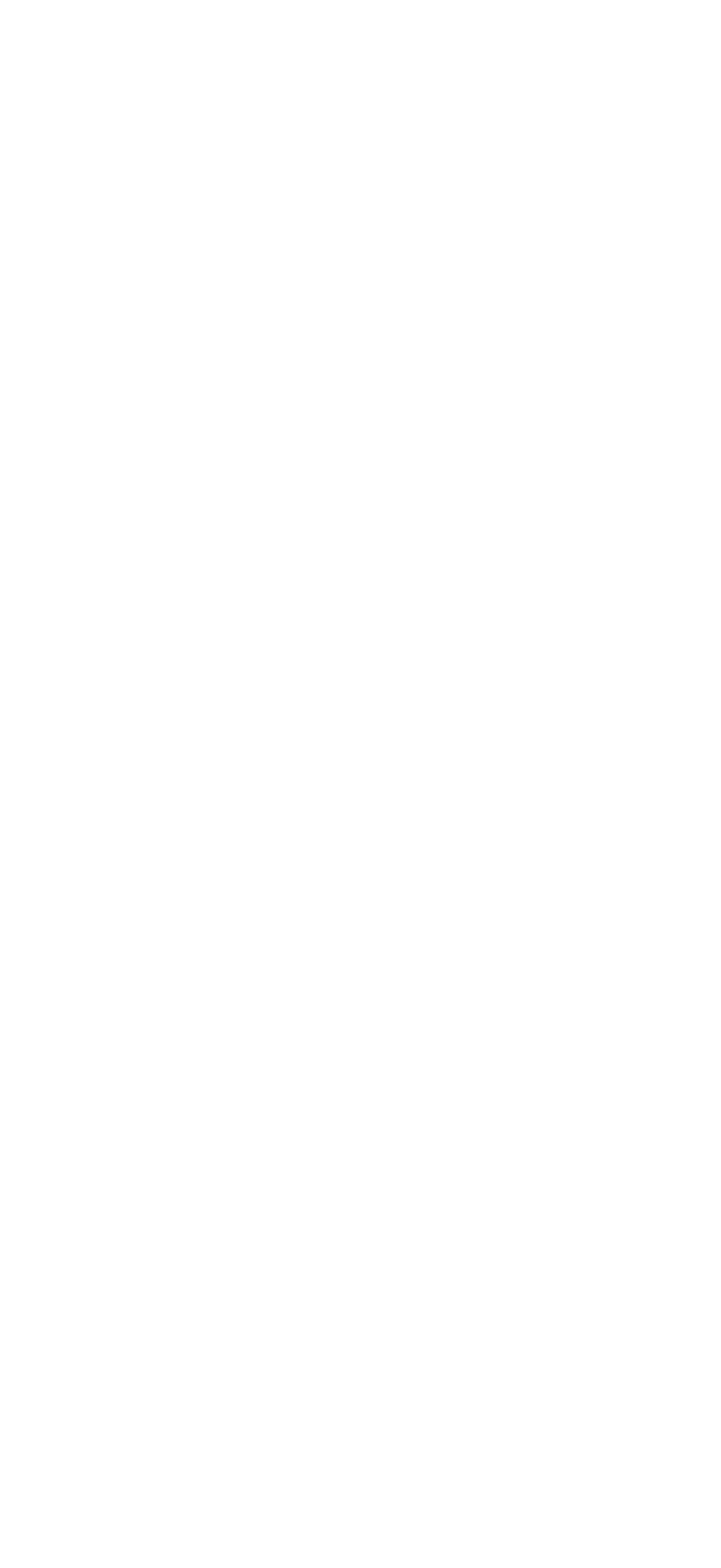التفاصيل
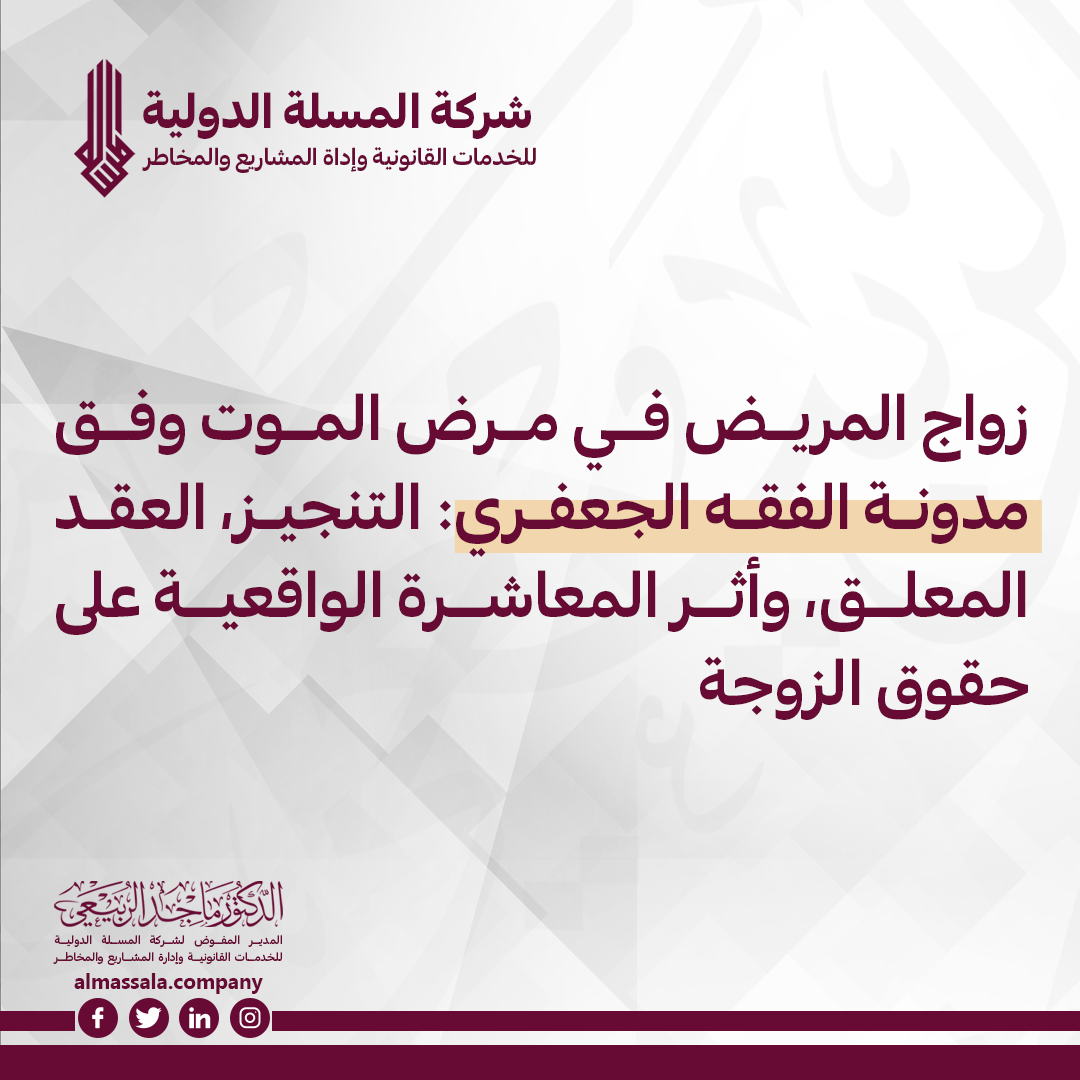
زواج المريض في مرض الموت وفق مدونة الفقه الجعفري
زواج
المريض في مرض الموت وفق مدونة الفقه الجعفري: التنجيز، العقد المعلق، وأثر
المعاشرة الواقعية على حقوق الزوجة
يشكل
زواج المريض في مرض الموت مسألة فقهية وقانونية معقدة، إذ تتقاطع نصوص مدونة الفقه
الجعفري مع الفراغ التشريعي في القانون وتبرز عدة إشكالات حول صحة العقد، وطبيعة
الشرط المعلق عليه، وواقعية المعاشرة قبل تحقق الدخول. المادة (64) من المدونة تنص
صراحة على أن عقد الزواج في حالة المرض المتصل بالموت يصح بشرط الدخول، وأن غياب
تحقق هذا الشرط قبل وفاة الزوج يؤدي إلى بطلان العقد بأثر رجعي، فلا تترتب للزوجة
أي حقوق مالية أو إرثية أو عدة. هذا الشرط يصنف كـ شرط فاسخ؛ أي أن العقد صحيح
شكلياً عند انعقاده، لكنه يرتبط أثره بتحقق الدخول، فإذا لم يتحقق ينحل العقد
بالكامل بلا أي أثر قانوني.
هنا
يبرز التناقض مع مبدأ التنجيز الوارد في المادة (2) فقرة خامساً من المدونة، التي
تشدد على أن يكون العقد نافذاً فور انعقاده، وأنه لا يجوز تعليقه على أمور
مستقبلية محتملة أو غير مؤكدة. المادة (64) تشكل استثناءً واضحاً لهذا المبدأ، حيث
تسمح بتعليق الزواج على شرط مستقبل محتمل (الدخول قبل الوفاة)، ما يفتح الباب
لتباين في التفسير القضائي ويثير إشكالاً منهجياً حول اتساق النصوص: هل يجوز
استثناء التنجيز لحالات مرض الموت؟ أم أن هذا الاستثناء يخلق فراغاً تنظيمياً يهدد
العدالة الواقعية للزوجة؟
تزداد
المسألة تعقيداً عند حدوث المعاشرة الزوجية الواقعية قبل تحقق الدخول، والتي تشمل
السكن المشترك، التبرج، المشاركة في الحياة اليومية، والتصرف بوظائف الزوجة
العادية. من منظور المدونة، هذه المعاشرة لا تنتج أي أثر شرعي أو مالي، فالعقد
معلق على شرط فاسخ لم يتحقق، ويبقى الأثر القانوني غائباً تماماً رغم الواقع
العملي. هذا الفصل بين الواقع الاجتماعي للأفعال الزوجية والأثر القانوني للعقد
يوضح حرص النص الفقهي على منع الزواج الشكلي، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن إهدار
محتمل لحقوق الزوجة حسنة النية، التي تصرفت وفق توقع طبيعي لاستمرارية الزواج دون
معرفة أنها ستحرم من الحقوق المالية والإرثية لمجرد عدم تحقق الدخول.
إضافة
إلى ما تقدم، تبرز إشكالية لغوية–قانونية
في صياغة المادة (64) من مدونة الفقه الجعفري، إذ إن النص جاء محصوراً بلفظ “الزوج”
أي الرجل، دون أن يمتد حكمه إلى المرأة المريضة مرض الموت. وهذا يخالف الصياغة التشريعية
المعتادة التي جرى العمل بها في التشريعات العراقية، حيث نصت المادة (3) من قانون النشر
في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 صراحة على أن: “ينصرف لفظ المذكر إلى المؤنث،
والمفرد إلى المثنى والجمع، والشخص إلى الشخص الطبيعي والمعنوي أينما ورد ذلك فيما
ينشر في الوقائع العراقية، ما لم يوجد نص أو تدل قرينة على خلافه.” وبالرجوع إلى
المدونة، لا نجد ما يدل على امتداد حكم المادة (64) إلى المرأة، الأمر الذي يثير
تساؤلاً جوهرياً: ما الحكم إذا كانت الزوجة هي المريضة مرض الموت ولم يتحقق
الدخول؟ هذا الصمت التشريعي يترك فراغاً واضحاً ويضع الزوجة حسنة النية في موقع
ضعف مضاعف، إذ يسقط عنها النص أي حماية قانونية مقارنة بالرجل، ويكشف بذلك عن قصور
في بناء الأحكام بما ينسجم مع مبدأ العدالة الواقعية والمساواة أمام النصوص
القانونية.
ختاماً،
تبرز احكام زواج المريض في مرض الموت وفق مدونة الفقه الجعفري تناقضاً جوهرياً بين
حماية الشكلية والعدالة الواقعية. المادة (64)، رغم وضوحها الوقائي، تفرض بطلان
العقد عند عدم تحقق شرط الدخول، مما يحرم الزوجة حسنة النية من أي حقوق مالية أو
إرثية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التوافق بين هذا النص وبين المبادئ القانونية
العامة في حماية الأطراف الضعيفة وضمان حسن النية في المعاملات. علاوة على ذلك،
المدونة لم تتناول بشكل صريح حالة المرأة المريضة غير المدخول فيها، وهو فراغ
تشريعي وفقهي يجعل تطبيق النصوص محدوداً ويضع الزوجة في موقف قانوني هش. من منظور
نقدي، هذا يظهر قصوراً منهجياً في الصياغة القانونية للمدونة، إذ أنها تقدم قاعدة
صارمة للوقاية من الشكلية لكنها تتجاهل التوازن بين حماية الشكل وحقوق الأطراف
الواقعية، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في مدى اتساق النصوص
الفقهية مع مبادئ العدالة الواقعية وحماية الضعفاء وفق القانون.